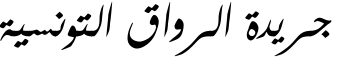يتذكر العديد من الناس مرحلة الطفولة باعتبارها مرحلة سعيدة وهانئة في حياتهم، مسكونة بمشاعر محبة وذكريات ناعمة مع الأهل والأجداد كما يتذكرها الآباء والأمهات باعتبارها أمتع الأوقات، حيث تشكل ولادة طفل جديد في الأسرة حدثاً في منتهى السعادة، والأجمل منه المشاعر المرتبطة برعاية هذا الطفل، ومتابعة نموه حتى يبلغ مرحلة الشباب.
لكن البعض الآخر يدرك أن مرحلة الطفولة يمكن أن تكون منبعاً لذكريات مؤلمة وأن جراحها قد ترافق المرء طوال حياته، حيث تترك تجارب الطفولة الصادمة، مثلها مثل تجارب الكبار، آثارا مريرة على واجهة الحياة النفسية؛ فسوء المعاملة والفقر والحروب والإصابات والحرمان من الحقوق، ليس بإمكانها أن تمر مرور الكرام على مشاعر رقيقة مثل مشاعر طفل، لا حول له ولا قوة.تستعرض الدكتورة مارلين برايس ميشيل – الأستاذة في معهد الابتكار الاجتماعي ومتخصصة في التنمية البشرية في جامعة سانتا باربرا في ولاية كاليفورنيا الأميركية – نتائج دراسات حديثة تؤكد على أن معدلات الصحة النفسية لطلاب بعض الجامعات الأميركية قد سجلت أدنى مستوياتها من خلال النتائج التي استخدمت هؤلاء الطلاب فيها كعينات للبحوث المتخصصة، حيث سجلت زيادة مطردة في مستويات القلق والاكتئاب والأمراض النفسية المختلفة.
وحتى نوفر له الفرصة ليضع قدمه على أول طريق العلاج يتوجب أن يستثار دماغه بطرق جديدة ومبتكرة للاستجابة لهذا العلاج، ولعل أفضل من يقدم مثل هذه الخدمة للطفل هم البالغون من المقربين في محيطه الاجتماعي الذين يضع ثقته فيهم ويطمئن بوجودهم.وترى شارون ستانلي – وهي أستاذة في الطب النفسي – أن رفع أعباء الماضي بكل ما يحمله من ذكريات مريرة يعتمد على أهمية تبادل هذه الخبرات المؤلمة مع أولئك الذين لديهم استعداد نفسي لأن يسمعونا ويتواصلون نفسياً مع شكوانا وهمومنا
متخصصون ينصحون الأهل والمربين بضرورة خلق طقوس وأماكن آمنة للأطفال للتعبير عن أنفسهم
هذا الكتاب الذي رُصد لاستخدام المتخصصين في العلاج النفسي، يذكرنا بالدور المهم الذي يلعبه الآباء والأمهات والمعلمون والمرشدون النفسيون في تقديم العون للأطفال، لانتشالهم من التأثيرات السلبية التي تتركها على أرواحهم أحداث وصدمات الطفولة
ومن قائمة أهم الأبحاث والدراسات التي اعتمدتها ستانلي في مؤلفها، هنالك جملة من الإرشادات التي يتعين على الأهل والمربين ملاحقتها ليقوموا بهذا الدور الخطير والإيجابي في حياة أطفالهم، وأهمها أن يكونوا على استعداد تام للاستماع والإنصات وإظهار الاهتمام بما يقوله الطفل ومراقبة تعبيراته الجسدية أيضا، وضرورة تعزيز الوعي الجسدي؛ بمعنى بدلاً من أن نسأل الطفل”كيف تشعر؟” ينبغي أن يكون سؤالنا أكثر دقة “في أي مكان من جسدك تشعر بالخوف، الغضب، الحزن تحديداً؟”.وترى ستانلي أن الأطفال غالباً ما يربطون بين مشاعرهم وأجسادهم، ونحن عندما نخلق هذا النوع من الحوار المباشر مع الطفل فإننا سننظر إلى مشكلته عن كثب أكثر ونستمع له بشكل أكثر دقة، وعندما يصبح هذا الطفل واعياً بما يعانيه جسده، إضافة إلى أعراضه النفسية، ستصل رسائل الوعي هذه مباشرة إلى الدماغ ومن شأنها أن تدفع الدماغ إلى إرسال إشارات مقابلة إلى أجزاء الجسد لتستعيد نشاطها.
وينصح متخصصون الأهل والمربين بضرورة خلق طقوس وأماكن آمنة للأطفال للتعبير عن أنفسهم، واستكشاف مشاعرهم وذلك بتوجيههم إلى آفاق المعرفة والفنون والموسيقى والرقص والممارسات التأملية بشكل يجسد للطفل ما يعنيه أن يكون إنسانا، وهذه الأمور من شأنها أن تعمل على توظيف أجزاء المخ المسؤولة عن تحويل مشاعر مثل الخوف إلى حب وثقة وتسهل عملية النمو والتطور.
في حين أن التعاطف الجسدي هو جزء من لغة الحوار هذه وهو يختلف عن التعاطف المعرفي الذي يقوم على أساس محاولة فهم ما يفكر فيه الآخرون؛ فالتعاطف الجسدي هو محاولة الشعور بما يحس به الآخرون، وبإمكاننا أن نتفاعل معهم. وعندما يشعر الطفل بآلام في معدته وضيق في صدره مثلاً، يمكن للأهل أن يقوموا بتقصي جذور هذا الألم من خلال إظهار تعاطفنا مع آلامه وتوجيه وعيه إلى مكامن الألم الجسدي لتعزيز معرفته بذاته، فقد تكون الأعراض جسدية والمسببات نفسيةمن ناحيتها، تتطرق الدكتورة مارلين برايس ميشيل في كتابها “صُناع التغيير” إلى أن الآليات الثلاث السابقة يمكنها أن تكون ممارسات يومية يتبناها الأهل والمربون، في محاولة لمساعدة الأطفال والمراهقين على تخطي الصدمات النفسية، ولكن يحتاج الطفل في بعض الأحيان إلى مساعدة يقوم بها متخصصون في المجال النفسي، إذا كانت تجربته عميقة ومعاناته كبيرة خاصة أن مدارس العلاج النفسي تعتمد في مثل هذه الحالات لغة التواصل والتفهّم الجسدي بين طرفي العلاج وهي طرق حديثة في هذا المضمار حققت نتائج جيدة وملموسة
وتنصح ميشيل الكبار أيضا بمحاولة البحث عن علاج لتجاربهم الشخصية، فالأوان لم يفت بعد ويمكن لجروح الطفولة أن تلتئم بقليل من الوعي الاهتمام